
القدّيس قزما الإيتولي
القدّيس قزما الإيتوليّ
وُلد في قرية صغيرة من قرى إيتولا، ميغاداندرون، من أبرشيّة أرتا. كان ذلك حوالي العام 1714 م.
أنشأه أبواه، وكانا بسيطَين تقيََّين، في مخافة الله ومحبّة الكتب المقدّسة.
![]() حوالي سنّ العشرين أقام في الجبل المقدّس، آثوس، تلميذاً في الأكاديميّة الملحقة بدير فاتوبيذي، حيث علّم معلّم مشهور اسمه أفجانيوس بولغاريس.
حوالي سنّ العشرين أقام في الجبل المقدّس، آثوس، تلميذاً في الأكاديميّة الملحقة بدير فاتوبيذي، حيث علّم معلّم مشهور اسمه أفجانيوس بولغاريس.
غير أنّ ردود الفعل التي أثارها تأسيس هذه المؤسّسة التي أخذت تبثّ روح الأنوار (القرن الثّامن عشر) في قلب قلعة الأرثوذكسيّة، أجبرت بولغاريس وسواه من المعلِّمين الشهيرين على مغادرة آثوس، فانحطّت، سريعاً، حال الأكاديميّة (1759).
هذا كان للفتى قوزما إشارة إلى التّدبير الإلهيّ، فقد تخلّى عن فكرة الدّراسة وانخرط في الحياة الرّهبانيّة في دير فيلوثيو حيث أهّلته غيرته وجهاداته النسكيّة وتقواه للسّيامة الكهنوتيّة، بعد قليل من اقتباله النّذور الرّهبانيّة.
منذ فتوّته كانت للمغبوط رغبة جامحة في نشر كلمة الله حوله لدرجة قال معها إنّ هاجس خلاص إخوته كان يتآكله كما تفعل الدّودة بالشّجرة من الداخل. في تلك الأوقات العصيبة من تاريخ الشّعب اليونانيّ المقهور، كان جهل أساسيّات الإيمان والثّقافة المسيحيّة يؤدّي إلى إهمال الأخلاق وانحطاطها بحيث كانت الكرازة بالإنجيل تفرض نفسها كحاجة ولا ألحّ. لكنّه وَفق ما بثّه في نفسه تعليمُ الآباء القدّيسين، لم يشأ قوزما أن يخوض في الحياة الرسوليّة من ذاته. رغب في أن يعرف ما إذا كانت هذه مشيئة الله ففتح، يوماً، الكتاب المقدّس عفواً ووقع على هذا القول للرّسول المصطفى بولس: "لا يطلبّن أحد ما لنفسه بل كلّ واحد ما هو للآخر" (1 كو 10: 24). على هذا استنار بكلمة الله.
وبعدما استمزج آراء الآباء الروحيّين في الجبل المقدّس، توجّه إلى القسطنطينيّة طلباً للإذن والبركة من البطريرك سيرافيم الثّاني (1757 – 1761 م). كما رغب في أن يتابع هناك بعض دروس الخطابة لدى أخيه، الأرشمندريت خريسنثوس، الذي أضحى، فيما بعد، مدير الأكاديميّة البطريركيّة ثمّ مدرسة ناكسوس.
باشر الرّسول الجديد عمله البشاريّ في كنائس نواحي القسطنطينيّة، ثمّ توغّل في المناطق الغربيّة من اليونان وعاد إلى القسطنطينيّة. بعد ذلك اعتزل لبعض الوقت في آثوس ثمّ أعطاه البطريرك صفرونيوس الثّاني (1774 – 1780) البركة ليبشّر في أرخبيل السّيكلاديس تعزية للسكّان المُحبطين إثر إخفاق محاولة التّمرّد التي أثارتها روسيا سنة 1775 م. من هناك عاد ليختلي في الأديرة مُكمِّلاً من الإقامة في الجبل المقدّس سبعة عشر عاماً. لكنّ محبّة إخوته دفعته، مرّة أخرى، إلى المغادرة، هذه المرّة إلى تسالونيكي حيث أقام لبعض الوقت في بيريا ثمّ جال في كلّ مقدونية يجمع حشوداً من المؤمنين الذين أصغوا إليه بنخس قلب.
من كافالونية توجّه إلى جزيرة زاكنثوس ثمّ إلى كورفو ومن هناك عبر إلى الأبيروس حيث كانت المسيحيّة في حال من الشّقاء. غرضه كان أن يثبِّت الإيمان الأرثوذكسيّ في الشّعب ويحول دون اقتبال السكّان للإسلام. وإذ أعانت القدّيس قوزما نعمة الله، صنع في تلك النّواحي عجائب حيث لا زالت أصداء أعماله البشاريّة تتردّد إلى اليوم. وقد تمكّن، إلى حدّ بعيد، بمواعظه، من تقويم أخلاق المسيحيّين.
كلامه كان بسيطاً، في متناول الجميع، يستعين بالصّور والتّعابير المستعارة من الحياة اليوميّة. لكنْ، كان كلامُه، أيضاً، مشبعاً بالوداعة والسّلام والفرح الذي وحده الرّوح القدس يُسبغه. كانت أقواله تتغلغل في نفوس سامعيه فيقتبلونها، للحال، بغيرة بمثابة تعبير عن مشيئة الله. وإذ لم تكن هناك كنائس تسع الجموع فإنّهم كانوا يجتمعون إليه في الهواء الطلق، على منبر متنقّل، بقرب صليب كبير غرزه في الأرض، ثمّ صار، بعد رحيله، نبعاً للأشفية وتخفيفاً للآلام الجسديّة والرّوحيّة. كان يعلّم المسيحيّين أن يعيشوا وفق وصايا المسيح وأن يحفظوا الأحد، الذي هو يوم الرّبّ، طارحين جانباً مشاغلهم ليذهبوا إلى الكنيسة ويُصغوا إلى كلمة الله. حيثما عبر كان يؤسّس المدارس. هذه كانت مهمّة أساسيّة في اعتباره. في هذه المدارس كانوا يتعلّمون، مجّاناً، اللغة اليونانيّة والكتب المقدّسة. أقنع الأغنياء بأن يخصّصوا الفائض لديهم للإحسان وتوزيع كتب التّقوى والصّلبان والمسابح وحثّهم، أيضاً، على أن يقدّموا للكنائس أجراناً للمعمودية لتعميد الأولاد.
كان هناك جمع يعدّ ألفين إلى ثلاثة آلاف يتبعونه حيثما ذهب بحيث شكّلوا جيشاً حقيقيّاً للمسيح في ألبانيا. كانوا ينظرون إليه باعتباره أخنوخ أو النبيّ إيليّا أتى ليبشّر بفجر زمن جديد. قبل أن يباشر كرازته كان يقيم خدمة صلاة الغروب أو البراكليسي لوالدة الإله. ثمّ، بعد أن يتكلّم، كان يترك لما يقرب من الخمسين كاهناً، رافقوه، أن يتابعوا عمله في قبول اعترافات المؤمنين وإقامة صلاة الزّيت ومناولة الشّعب وزيارة كلّ مؤمن شخصيّاً.
ومع أنّ تعليم القدّيس لم تكن له نكهة جدليّة بل انحصر في تعليم الفضائل الإنجيليّة، ورغم أنّه لمّا مثَل أمام الباشا في يوانينا عامله هذا الأخير بالكثير من الإكرام، فإنّ بعض اليهود أغاظهم أن يُنقَل السّوق من الأحد إلى السّبت. وقد سعى هؤلاء لدى الباشا إلى التخلّص من قوزما.
اعتاد قدّيس الله، كلّما بلغ موضعاً رغب في التّبشير فيه، أن يذهب أوّلاً إلى أسقف المحلّة لأخذ بركته. ثمّ يرسل، بعد ذلك، بعض تلاميذه للحصول على تصريح من السّلطة العثمانيّة المحلّية. بلغ، ذات يوم، قرية من قرى ألبانيا تدعى كوليكونتاسي، فعلم أنّ حاكم المنطقة، قورت باشا، يقيم غير بعيد من هناك، في بيراتي. ورغم النّصائح التي وجّهها إليه المحيطون به، قرّر القدّيس أن يذهب بنفسه إلى المفوّضيّة المحلّية للحصول على تصريح السّلطة المدنيّة، فقيل له إنّ الأمر صدر بتحويله إلى كورت باشا. فهم قوزما أنّ الوقت حان له أن يتوِّج عمله بالشهادة، فشكر الله الذي أهّله لمثل هذا الشّرف.
في اليوم التّالي، 24 آب سنة 1779 م، رافقه سبعة جنود بحجّة أنّهم يريدون أخذه إلى الباشا. ولكن، بعد ساعتين من السّير في الطريق توقّفوا بقرب نهر باسو وأخبروه أنّه حُكم عليه بالموت. امتلأ فرحاً وشكر الله ثمّ بارك بعلامة الصّليب أربع جهّات الأرض ورفع صلاة من أجل خلاص كلّ المسيحيّين. ولمّا أتمّ ما رغب فيه رفض أن يقيِّدوا يديه لكي يحفظهما في شكل صليب. ولمّا شنقوه لم يبدِ أيّة مقاومة. هكذا أسلم الرّوح بتمجيد. كان قد بلغ الخامسة والسّتّين.
ألقى جلاّدوه جسده في النهر. بعد ثلاثة أيّام اكتشفه كاهن اسمه مرقص، إثر صلاة، وكان كأنّه واقف حيّ. أخرجوه من الماء وبعد أن ألبسوه ثيابه الرّهبانيّة واروه الثّرى بإكرام. وقد جرت عند ضريحه وبرفاته، بعد ذلك، عجائب عدّة. سنة 1813 عمد علي باشا، الذي على يوانينا، والذي كان قوزما قد تنبّأ له بمستقبل مجيد، إلى بناء كنيسة ودير بقرب الضّريح وقدّم جمجمته، في علبة من فضّة، إلى زوجته المسيحيّة فاسيليكي.
اعتُبر قوزما الشّهيد أميراً للشّهداء ورسولاً جديداً. هكذا أكرمه الشّعب من وقت استشهاده. لكنْ لم تُعلَن قداسته رسميّاً إلاّ في العام 1961، من البطريركيّة المسكونيّة.
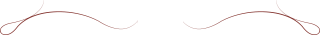
2026-02-11
رئيس لجنة الشؤون الكنسية…
2026-02-15
رسالة الصوم الأربعيني المقدس 2026
2026-02-22
صلاة الغفران
2026-02-27
صلاة المديح الأول
2026-03-01
قداس الأحد الأول من الصوم







